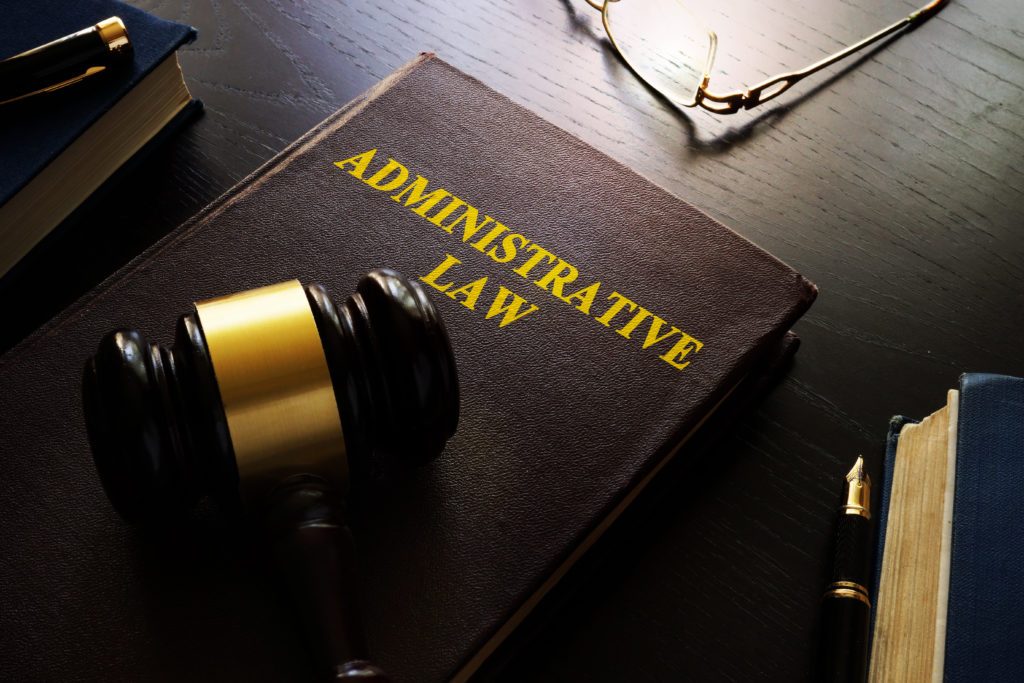تأثير بُنى الجهاز البيروقراطي في مسار الإصلاح الإداري
مع اكتمال بناء الدولة في أوروبا، ظهر التنافس في مسائل شرعنة الآليات الإدارية الكبيرة ودسترتها. ومن ثم ظهر تحول جذري باتجاه حكم القانون والاعتماد على البيروقراطية كأداة رئيسية للتغيير المؤسسي والحراك الاجتماعي. وانعكس ذلك التحول على مؤسسات التدريب الرسمي وكذا على الخطاب الأكاديمي والأجندات السياسية. بذلك، برز التوجه نحو جعل مخرجات مؤسسات تدريب وتأهيل الموارد البشرية أكثر ملائمة لحاجات الأجهزة البيروقراطية من هذه الموارد، وأصبحت عمليات تصميم الهياكل البيروقراطية تخضع لمعايير علمية، وتشترط وجود توصيف وظيفي دقيق للوظائف العامة والموظفين الذين سيشغلونها.
في الحالة اليمنية، تشكل الجهاز البيروقراطي للدولة بملامحه وبِنيته الحالية، عقب تأسيس دولة "الجمهورية اليمنية" في مايو- ماي 1990. في سياق وحدة اندماجية أدمج بواسطتها الجهازين البيروقراطيين اللذين كانا قائمين في الدولتين الشطريتين قبل الوحدة، والواقع أن التباينات بين الجهازين كانت عديدة ولا تختلف كثيرا عن تلك التباينات والاختلافات التي كانت قائمة بين النظامين السياسيين السابقين وظل كل منهما يمارس إدارة دولة الوحدة بطريقته رغم انخراطهما في نظام سياسي جديد.
تبنت الأحزاب الحاكمة في الجمهورية اليمنية منذ بداية الوحدة مشاريع عديدة للإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والسياسي. وفي هذا السياق، استُهدف الجهاز البيروقراطي الجديد بجملة من البرامج والاستراتيجيات الإصلاحية التي حُكمت في كل مرة بإيديولوجيات وثقافات تلك الأحزاب. وقد انعكس ذلك على طبيعة البنى الرئيسية المكونة للجهاز البيروقراطي، واضفى عليها جمله من الاختلالات والانحرافات التي حالت دون استكمال مسار إصلاح هذا الجهاز، الأمر شكل أحد أبرز أسباب تعثر مشروع الإصلاح الإداري الشامل في الدولة ككل. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه الاختلالات والانحرافات، بعضها يمثل جزء من الموروث الذي خلفته إدارة الشطرين السابقين، وبعضها اكتسبها الجهاز البيروقراطي لاحقا بفعل العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وعليه، فإن هذا البحث يحاول الإجابة السؤال التالي:
يختص هذا المبحث بتقديم إطار نظري للمفاهيم الرئيسة الواردة في عنوان البحث، وهما: مفهوم البيروقراطية (أ)، ومفهوم الإصلاح الإداري (ب).
اقترن مفهوم البيروقراطية في أصوله الإنجليزية (bureau- cracy)، والفرنسيّة (bureaucratie)، من كلمة (bureau) للدلالة على المكتب الذي يجلس خلفه الموظف الحكومي، ثم اتسع مدلولها ليشير إلى غرفة المكتب بأكملها، وتشير لفظة: (cracy) الانجليزية أو (cratie) الفرنسية إلى معنى "القوة" المشتق من الكلمة القديمة (kratia) أي أن تكون قويًا (to be stong)، ومن ثم يصبح مدلول كلمة بيروقراطيّة ممارسة السلطة أو الحكم أو القُّوة عن طريق المكاتب[1].
ومن حيث الاصطلاح يشير مفهوم البيروقراطية لدى علماء السياسة والإدارة والاجتماع إلى مدلولين أحدهما أكاديمي، والآخر عام، أما الأكاديمي فله استعمالين، الأول؛ تقليديّ، مفاده أنّ البيروقراطية هي الحكم بواسطة المكاتب - أو «حكم الموظفين» المعينين والمنضمين إلى السُلّم الإداري، ويخضعون إلى سلطة إشراف عليا، وليس حكم السياسيين المنتخبين أو الحكام الوراثيين[2]. فيم جاء الاستعمال الثاني - الحديث - مع ماكس ڤِيبر جاعلا منه مركزيّا في نظريّته حول تنظيم وإصلاح إدارة الدولة، متيحا بهذه الصيغة فهم السيطرة/ الهيمنة المشـروعة أو العقلانيـة البيروقراطية. حيث ميّز «ڤِيبر» بين ثلاثة أشكال لهذه السيطرة: الأولى: «تقليديّة» تستند إلى العادات والدين والوراثة، والثانية: «كاريزميّة» تقوم على الخضوع لما هو مقدس وبطولي وذو قيمة رمزية للشخص- صاحب السلطة، والثالثة؛ «عقلانيّة» تستند إلى القوانين والقواعد المؤسّسيّة المقررة وإلى حق الّذين يمارسون السلطة بهذه الوسائل في إصدار القرارات والسهر على تنفيذها. عن هذه الأخيرة يقول ڤِيبر: «السيادة القانونية بحكم النظام الأساسي/ اللائحة. ونموذجها الخالص هو السيادة البيروقراطية»[3].
إن مقاييس السيطرة العقلانية تختلف تماما عن أشكال النشاطات السياسية الأخرى التي لم تتمكن من التخلص من إرث التقاليد المحددة للحكم الشـرعي، ولا من الكاريزما المعتمدة على الزعامة الشخصية المرتكزة على العاطفة؛ إذ تستند السيطرة العقلانية على عناصر قانونيّة تجعل من السلطة مؤسسة عقلانية، عن طريق قواعد تجيز محاسبة الحكام والمحكومين وتعزز من وسائل إصلاح إدارة الحكم.
أما المدلول العام للبيروقراطية المتداول لدى عموم المجتمع فيحيل إلى الإجراءات السلبية التي تمارسها الأجهزة الإدارية للدولة، كالروتين اليومي الممل، وتعقيد الإجراءات، وكل ما يجعل من البيروقراطية مصطلحًا مرتبطًا بالعجز الإداري وسوء الأداء كما ينظر إليها كمرادف للتعقيد والتعسف الإداري في استخدام السلطة دون مبرر منطقي، ونظرًا لبروز هذا المدلول في الواقع، فإنّه يلاحظ استعماله أيضًا في الكتابات الأكاديمية؛ ليشير بعضهم عن طريقه إلى سوء التخطيط وغياب التنظيم وضعف التنسيق، وقصور دور القيادة وضعف الرقابة باعتبارها عيوب تنتجها البيروقراطيّة [4]، بهذا المعنى تقف البيروقراطية عائقاُ أمام مسار الإصلاح الإداري للدولة.
وتعد المقاربة البنائية الوظيفية أن الجهاز البيروقراطي نظام فرعي من النظام السياسي والاجتماعي، يؤدي أدوارًا ووظائف متعددة تعزز مسار الإصلاح الإداري [5]، في هذا السياق يأتي الحديث عن الاهتمام بإصلاح إدارة وظائف الدولة، عن طريق تقليص حجم بيروقراطية حكوماتها، رديفًا للترفيع في كفاءتها وحداثتها واستجابتها لحاجات المواطنين ضمن نسق يعرف بـ «إعادة اختراع الحكومة» الذي كان قد تبناه الرئيس الأمريكي كلينتون منذ بداية حملته الانتخابية، وأضاف امتيازات أخرى لحركة الإصلاح الحكومي في دول أخرى كثيرة[6].
وعليه يمكننا اعتماد تعريف إجرائي للبيروقراطية العامة، مفاده أنها: مجموعة من المعايير العلمية، والقواعد العقلانية التي تحكم عمل الأجهزة الإدارية للدولة، بما يضمن كفاءتها وفاعليتها.
الإصلاح في اللغة مصدر للفعل "أصلَح، وصَلُح"، وقد ورد هذا الأخير في معجم الوسيط بمعنى: «زال عن الفساد»، ويقال عن الشيء: هذا يصلح لك، إن كان نافعًا أو مناسبًا، وأصلح في عمله أو أمره أي أتى بما هو صالح ومفيد، وكلمة الإصلاح تأتي بمعنى الترميم- أي رأب الصدع الّذي يصيب الشيء، أو إصلاح الخلل فيه[7].
وفي الاصطلاح عرّف قاموس "أُوكسفورد" الإصلاح «Reform» أنه: «تعديل أو تبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات التناقص، لاسيما في المؤسّسات والممارسات السياسيّة الفاسدة أو الجائرة من أجل إزالة بعض التعسف أو الخطأ»، وعرّفه القاموس أيضًا أنه: «تقويم وتغيير بغية التحسين» [8]، فهو ينطوي جوهريًا على فكرة التغيِير نحو الأحسن ويوازي فكرة التطور والتقدم، وفي قاموس "لونقمان - الأمريكي" ورد الإصلاح بمعنى: «التغيِير الذي يطرأ أو يمس نظامًا أو منظمة من أجل تحسينها وتدارك نواقصها» [9]، ولا يختلف المدلول ذاته في اللغَة الفرنسية لاسيما في كلمتي (Réforme, Ajustement) اللتين تُشيران إلى التحسين ومعالجة الخلل[10].
وتُعرّف منظمة الأمم المتحدة الإصلاح الإداري أنه: مجهودات خصوصية تستهدف إدخال تغييرات أساسية في مؤسسات الدولة عن طريق إصلاحات على مستوى النظام برمته أو على الأقل تحسين واحدة أو أكثر من عناصره الرئيسة [11]، كما تعرفه المنظمة نفسها أنه يعني التأثير والاستخدام المتعمّد للسلطة من أجل تطبيق معايير جديدة في إدارة الدولة؛ بغرض تغيير الأهداف والهياكل والعمليات وتحسينها خدمة للتنمية [12]، وفي الوقت الحاضر تتبنى البرامج والمنظمات الدولية كـ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجموعة البنك الدولي" مفاهيم «الحكم الصالح، الحكم الرشيد، الحِكامة» كمصطلحات حديثة لبناء الدولة العصـريّة وإصلاح إدارتها، وتتضمن المفاهيم المشار إليها مبادئ أساسية للإصلاح أهمها: "سيادة حكم القانون، الشفافية، الاستجابة/القابلية، بناء التوافق، المساواة، الفاعلية والرؤية الاستراتيجية"[13].
ويجري التعاطي مع مفهوم الإصلاح الإداري أحيانًا كمفهوم مرادف لبعص المفاهيم الأخرى، منها على مفهوم «التحديث» باعتباره لفظًا تقنيًا محايدًا يحيل على مجموع التغيِيرات الّتي تسمح لجماعة ما بتحكم أفضل في محيطها، ومفهوم «التنمية» بالنظر إلى أهمية الإصلاح في تحقيق عملية التنمية، حيث يعد "ميردال" التنمية عملية مرادفة للإصلاح بما هي «حركة صعود إلى أعلى تشمل النظام الاجتماعي بأسرة» [14]، وبالرغم من ذلك فإنّ الإصلاح يختلف عن التحديث من جهتين، الأولى: أن التحديث جزئي ويتصل بالجانب التقني، فيما يكون الإصلاح أكثر شمولية، والثانية: كون التحديث محدد بالانتقال من مجتمع تقليدي إلى آخر حديث، أما الإصلاح فيتسم بالمرونة ولا يشترط تقويض المجتمع التقليديّ أو المساس بقيمه الحضارية.
ويتضمن مفهوم إصلاح إدارة الدولة عمومًا حركةً أو تحريكًا في أوضاعها على صورة تغاير الحالة القديمة، وقد تكون الحركة بصورة جزئية في إطار مجال معين من الإصلاحات كالإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أوفي قطاع مؤسسـي معين، كالإصلاح التعليمي أو الزراعي أو الإعلامي، وقد تكون في رؤية شاملة تمتد إلى معظم القطاعات، وفي جميع الأحوال فإن كل مشروع إصلاحي في أي ميدان يتطلب إعدادًا مسبقًا وتغييرًا محددًا[15].
من كل ما سبق يمكننا اعتماد مفهوم الإصلاح الإداري في معناه الآتي: الجهود والأنشطة والسياسات التي تهدف إلى عقلنة الأجهزة البيروقراطية الحكومية وتطويرها وتحديثها وحوكمتها؛ بهدف ترشيق حجمها، وترشيد إنفاقها، وزيادة فاعليتها في خدمة المجتمع.
من أهم سمات الدولة العصرية امتلاكها للهياكل البيروقراطية الفاعلة، وتزداد أهمية هذه الهياكل مع امتداد حضور الدولة بشكلها الحديث في جميع المجالات، ويعد «ڤِيبر» أول من قدم تحليلا علميا للتنظيم البيروقراطي يعتبره الشكل الأكفأ من الناحية العقلانية في مواجهة الإدارة الجماهيرية[16].
وبعده جزءًا أساسيًا من المنهجية المعتمدة في هذا البحث، فإن النموذج البيروقراطي «الڤِيبري» يفرض علينا محاولة تطبيق معاييره على بِنية الهياكل البيروقراطية اليمنية؛ إذ إن تصميم الهياكل البيروقراطية - بطريقة لا تستند إلى الأُسس والمقومات التنظيمية السليمة - يسهم في بروز ظواهر الانحراف والفساد الإداري في أجهزة الدولة ومؤسساتها [17]، وحيثما صممت الهياكل بطريقة غير ملاءمة لأهداف الأجهزة والمؤسسات، برزت مظاهر التخلف البيروقراطي والإداري؛ لذا نجد أن النموذج «الڤِيبري» يركز في عملية بناء الهياكل البيروقراطية بدرجة أساسية على معياري: التدرُج الهرمي للسلطة (أ) وتقسيم العمل (ب).
تضم البيروقراطية عند ڤِيبر تدرجًا هرميًا وترتيبًا إداريًا للسلطة، يقوم على مستويات الواجبات الرسمية، ويقصد بهذا التدرج: «نسق/ نظام مرتب من مصالح تخضع لنظام أعلى ونظام أسفل، وتكون فيه المصالح السفلى تحت رقابة المصالح العليا، وفي أوج تطور هذا النمط يكون الترتيب الإداري منظمًا بحسب سلطة أُحادية الاتجاه» [18]. إنه يربط هنا بين الشـرعية العقلانية من جهة، وبين التسلسل الهرمي للسلطة أو «الهيراركية/ التراتبية» من جهة أخرى [19]، بما هي رافعة للإنتاجية والفاعلية، وتحترم اللوائح القانونية والتنظيمية غير الخاضعة لمزاج الرئيس أو المدير الإداري، وتعمل على وحدة سلطة الأمر والقرار ونطاق الإشراف، ويبدأ تطبيق هذا التدرج من عملية بناء وتصميم الهيكل البيروقراطي [20]، حيث يتم تنظيم المراكز والوظائف طبقًا لقواعد محددة تخضع بموجبه المراكز الدنيا لسلطة وإشراف المراكز العليا في السلم الهرمي.
وبتطبيق خصائص هذا المعيار على الهيكل البيروقراطي اليمني نجد أن هذا الأخير يفتقر إلى معظمها، فعلى سبيل الذكر يفرض معيار التدرج اتساع الهيكل البيروقراطي عند القاعدة وضيقه عند القمة، هذه الخاصية تغيب عن معظم هياكل الوحدات المركـزية فـي الحالة اليمنية، إذا نلاحظ وجود إفراط ملحوظ في معدل الإدارات في المستويات العليا لا يتناسب مع الإدارات في المستويات الوسطى والدنيا. لعل ذلك يعزى إلى إشكالية تضخم المناصب القيادية، التي فرضتها ظروف التعيينات السياسية التي خلقت مناصب زائدة عن حاجة الأجهزة البيروقراطية، ويركز معيار تدرج السلطة على أن مركز السلطة يكون في أعلى الهيكل، مع السماح بتدفق المعلومات بشكل عام من أعلى إلى أسفل، أو العكس، الأمر الذي يشجع على خلق ثقافة عمل تركز على القواعد والمعايير، ويُفسِـر في الآن ذاته الطبيعة المركزية لعملية صناعة القرار واتخاذه في التنظيم البيروقراطي، في حين نجد عملية تدفق المعلومات والبيانات تجرى غالبًا باتجاه واحد في معظم الهياكل البيروقراطية اليمنية.
يهدف النموذج «الڤِيبري» من هذا المعيار إلى تقسيم العمل التنظيمي والإداري على أساس وظيفي، وإخضاعه لنطاقات قانونية رسمية[21]. وتعود الفكرة هنا إلى تقسيم نظام الإنتاج إلى مجموعة من مهام العمل أو المهن المُتخصِصة، بما يخلق اعتماد متبادل فيما بينها. في ظِلِ احتياج الأفراد إلى بعضهم بعض في إنتاج أغلب السلع التي يحتاجونها في إقامة واستمرار حياتهم في إطار النظم الرأسمالية[22]. وبموجب هذا المعيار، يقع بناء الهيكل البيروقراطي وإصلاحه بالاعتماد على التخصص في تحديد وحدات الهيكل وطبيعة العمليات التنظيمية وقنوات الاتِصال وترتيب الإدارات والوظائف بطريقة منظمة بحسب سُلطة أُحادية الاتجاه - دون أن يقصد بذلك تخويل السلطة العليا سحب أعمال المصالح الأدنى - ويقوم ترتيب الهيكل على فكرة التعقيد الذي يعكس درجة التمايز والاختلاف داخل المؤسسة، بحيث يكون ترتيب وحدات الهيكل عموديًا، وتشـرف كل وحدة على عدد من الأقسام والفروع بما يضمن الإشراف الدقيق والمساءلة، وهذا التعقيد يُعزى إلى أسباب كثيرة أهمها تنوع الوحدات الإدارية أفقيًا وعموديًا وجغرافيا. السؤال المطروح هنا: هل يعكس الهيكل البيروقراطي اليمني معيار التخصص وتقسيم العمل؟
في الواقع يبدو البناء البيروقراطي اليمني - إلى حد كبير - بعيدًا عن هذا المعيار، يتجلى ذلك بوضوح في التشخيص الذي قدمه أول برنامج حكومي للإصلاح «برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري- 1991» للأوضاع التي كانت قائمة منذ بداية الوحدة- ومنها أوضاع الجهاز البيروقراطي، حيث أشار البرنامج إلى إشكالية أساسية في هذا الشأن تمثلت في النمو الهيكلي البيروقراطي المتضخم[23] الذي نتج عن عملية توحيد ودمج هيئات ومؤسسات وأجهزة «الشطرين» السابقين، وأنتجت هيكلًا مشوهًا لا يعبر في الواقع عن احتياجات مجتمعية فعلية[24].
لقد شكلت الزيادة المبالغ فيها في حجم وتصنيفات وحدات الخدمة العامة، واحدة من أبرز مظاهر التضخم الهيكلي البيروقراطي، ويشمل ذلك زيادة عدد الحقائب الوزارية التي تضمنتها تشكيلات الحُكُومات اليمنية المتعاقبة منذ إعلان الوحدة، وكثرة التنظيمات الاستشارية وتعدد المجالس العليا، الذي انعكس عن طريق التصنيفات والمسميات التي أطلقت على وحدات الخدمة العامة "مؤسسات، أجهزة، هيئات، لجان، مراكز، مجالس... إلخ"[25]. في هذا السياق يظهر "المركز الوطني للمعلومات"، أن الحقائب الوزارية بلغت في فترات معينة أكثر من 45 حقيبة، فيما بلغت وحدات الخدمة العامة الأخرى حوالي 405 وحدة، موزعة على النحو الآتي: 20 مجلس، 200 دائرة، 10 مصالح، 36 مؤسسة، 29 هيئة، 32 شركة، 5 بنوك، 5 لجان وطنية وعامة، 12 مركزًا، 22 صندوقًا، 14 جهازًا، 7 معاهد تخصصية، 13 وحدة مختلفة [26]، فضلا عن وحدات السلطة المحلية التي بلغت في آخِر تقسيم إداري 22 محافظة بعد إنشاء محافظة أرخبيل سقطرى، فيما تتألف المحافظات من حوالي 333 وحدة فرعية تسمى مديريات.
كانت عملية المحاصصة السياسية للوظائف والمواقع القيادية في الجهاز البيروقراطي قد بدأت إبان المدة الانتقالية للوحدة تحت إدارة حُكُومة "المؤتمر، والاشتراكي"، ثم استمرت خلال إدارة حُكُومة "المؤتمر والإصلاح"، وبلغت ذروتها، في عهد حُكُومة «الوفاق الوطني» التي أدارت مرحلة الانتقال السياسي التي أعقبت انتفاضة 2011، وقد فاقمت هذه المحاصصة من حالة التضخم الهيكلي والبشـري، وعملت على خلق وحدات ليس الغرض منها سوى الاستيعاب الوظيفي للكادر القيادي والإداري للأحزاب الحاكمة.
ومع أن البرنامج المشار إليه قد حث على إعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي بالكامل؛ لمعالجة إشكالية التضخم الهيكلي، إلا أن «برنامج إعادة الهيكلة 1997- 2008م» لم يسفر سوى عن إعادة هيكلة 7 وحدات رئيسة - فقط - من وحدات الخدمة العامة [27]، علما أن هذا البرنامج هو جزء من مشـروع "استراتيجية تحديث الخدمة المدنية" الذي يعد - أيضًا - جزءًا من مشـروع أكبر أطلق عليه "برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي- 1995م"، ما جعل الحكومة تركز اهتمامها على الإصلاحات الاقتصادية على حساب الإصلاح البيروقراطي والإداري، يعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى ضغــوط الجهــات المانحة - لاسيما البنك الدولي - الذي بدأ إلى حدٍ كبير معنيًا بالإصلاحات الاقتصادية أكثر من الإصلاحات الأخرى.
يؤكد النموذج «الڤِيبري» على ضرورة وجود قواعد وإجراءات قانونية تنظم إصدار الأوامر وتنظم العمل الإداري بشكل كامل [28]، ويعرفها «فوكوياما» أنها: القواعد والإجراءات والوسائل النظامية التي تحكم جوانب الحياة المعاصرة كافة، ابتداءً بالحكومـات والجيـوش والمؤسـسات والشـركات، وانتهاءً بالنقابات والمنظمات الدينية والمؤسسات التعليمية، التي تجسدها البيروقراطية الحديثة تجسيدًا اجتماعيًا[29].
وتشكل أساس عمل الإدارة البيروقراطية، ومصدر موضوعي وعقلاني لتحديد مجال الصلاحيات أو حدود السلطة الرسمية، وتعمل على حساب السلوك المتوقع وتحقيق أعلى درجات الترشيد لهذا السلوك، وعلى الرغم من بعض المأخذ على رؤية ڤِيبر تجاه القواعد والنظم البيروقراطية [30]، إلا أنها شكلت محورًا أساسيًا في إدارة المؤسسات في الأنظمة المعتمدة على منهج الإدارة العلمية.
ولمعرفة تأثير النظم والقواعد المعتمدة في إدارة الأجهزة العامة على مسار إصلاح في البيروقراطية اليمنية لا بد من تحديد مدى التزام هذه الأخيرة ببعض المعايير الڤِيبرية ذات الصلة، لعل أهمها: معيار التدوين/ الكتابة والعمل المكتبي (أ)، ومعيار عدم الشخصنة - العقلانية (ب).
بحسب النموذج الڤِيبري لا بد أن تكون القواعد القانونية الحاكمة للجهاز البيروقراطي مكتوبة/مدونة حتى تصبح أكثر ثباتًا وإلزامًا، وأن تجري الإجراءات والمعاملات الرسمية بناء على وثائق مكتوبة وأوراق رسمية يحتفظ الموظفون بأصولها أو بصور منها في ملفات خاصة، وفي هذا الشأن يقول ماكس ڤِيبر في مؤلفه "الاقتصاد والمجتمع": «يستند سير الوظيفة الحديثة إلى أوراق رسمية (ملفات) يحتفظ بها في نسخ أصلية وإلى أفكار وكذلك إلى طاقم من الموظفين الصغار والكتبة من جميع الأصناف، ويمثل مجموع الموظفين العاملين في إدارة ما، بما في ذلك جهاز الملفات والممتلكات "المكتب"»[31].
وفي الواقع لا تختلف البيروقراطية اليمنية عن غيرها من البيروقراطيات العربية، في تفسيرها وتطبيقها الخاطئ لهذا المعيار وعلى نحو لا يتلاءم مع الغاية التي قصدها "ڤِيبر" منه، يقول: "بوحوش" في هذا الصدد: إن الإجراءات والقواعد البيروقراطية المكتوبة تحولت عبر البيروقراطيات العربية من المدلول الإيجابي الذي قصده ڤِيبر إلى مدلولات سلبية، كالجمود والروتين الممل والتعقيد؛ حتى باتت هذه الممارسات توصف من الناحية السياسية في عديد الكتابات بالدور الذي يقوم به الأشرار والفاسدون [32]، وإذا علمنا أن البيروقراطية اليمنية قد تأثرت بالتجربة المصـرية[33] التي عملت مصـر - عبد الناصر- على فرضها على الإدارة العمومية في اليمن منذ أوائل الستينيات، وظلت أثارها قائمة حتى اليوم وفقًا لما سبقت الإشارة إليه، أدركنا مدى ما تعانيه البيروقراطية اليمنية من هنات وإشكالات موضوعية في تطبيقها لهذا المعيار وكذا للمعايير البيروقراطية الأخرى.
في هذا السياق، يرى "مورو برجر" أن الإدارة العموميـة المصـرية مارست البيروقراطية بمدلولها السلبي الذي يختزلها في جملة الإجراءات السلبية للإجراءات والقواعد والأنشطة الإدارية التي يسيطر عليها التعقيد الشديد والروتين الممل الذي يقود إلى بطء إنجاز المعاملات، بل وإعاقتها غالبًا؛ ما جعل البيروقراطية مدخلا لممارسة الفساد الإداري، وإقحام العلاقات الشخصية في تسيِير العمل [34]، وقد ظهر ذلك جليًا بالنسبة للحالة اليمنية في اتِصال المواطنين بالخدمات العامة تحديدًا، حيث يكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية أن 7% من المواطنين اليمنيين يدفعون رشاوى وعمولات في هيئة رسوم غير قانونية، وذلك مقابل تسـريع حصولهم على بعض الخدمات العمومية [35]، وفضلًا عما ذكر فإن تشديد الإجراءات البيروقراطية وتعقيدها، قاد إلى إهمال قيمة الإداء والإنجاز لدى الموظفين العموميين وإلى ميلهم للتهرب من المسؤولية والاختفاء وراء التطبيق الحرفي للقوانين واللوائح دون أبداء أي مرونة في التعامل، حتى وإن كان ذلك على حساب المصلحة العامة.
يفترض النموذج الڤِيبري أن البيروقراطية تقوم على العقلانية المستندة إلى هيكل من القواعد والإجراءات القانونية المنظمة منطقيًا التي تُمثل الشكل الأكثر تقدمًا للسلطة المعقلنة، وأن صنع هذه القواعد والإجراءات وتنفيذها يكون وفق أُسس منهجية علمية وعقلانية دون الخضوع للآراء والمعايير الشخصية والميول العاطفية للموظفين، فالقواعد الموضوعية برأي ڤِيبر تحمي المواطن من تعسف الموظف، بشكل أساسي [36]، ويؤكد فوكوياما أيضًا على ذلك، بالقول: إن عدم الشخصنة يحد من رغبات المسؤولين في تحقيق مآربهم الشخصية، ويحدد حقوق وواجبات مرؤوسيهم[37].
وتبدأ عدم الشخصنة عند ڤِيبر بفصل العمل الوظيفي كدائرة منعزلة تمامًا عن مجال الحياة الخاصة بالموظف، عن طريق عزل مقر العمل الرسمي عن مقر سكنه الخاص، وفصل أموال الوظيفة وأدواتها عن ممتلكاته وأمواله الخاصة - حيث إنَّ الموظف لا يملك وظيفته ولا يمكنه نقلها - فضلًا عن الفصل بين المراسلات الرسمية والخاصة، وهو يستند في ذلك إلى ما يقوم به رجل الأعمال الحديث الذي يتصـرف كـ «موظف أول» في شركته ويتصـرف كالحاكم الذي يصف نفسه أنه «الخادم الأول» في دولة حديثة تتسم بالبيروقراطية العقلانية [38]، ولكن: هل تتسم البيروقراطية اليمنية بعدم شخصنة الإدارة؟ وهل يلتزم موظفيها بالفصل بين الخاص والعام؟
في الواقع أن سلوك النظام السياسي اليمني عمومًا- وعلى مستوى رئيس الدولة- في تعامله مع كرسي الحكم بصفته ملكًا خاصًا، وعدم قبوله بفكرة التداول السلمي على السلطة، وسيطرة فكرة القيادة الملهمة التي لا بديل عنها في أسلوب إدارة الحكم، فضلا عن تعامل الحاكم مع المال العام وممتلكات وموارد الدولة بأسلوب السياسات الاقطاعية. كل ذلك انعكس تماما على سلوك القيادات البيروقراطية ومن ثم على سلوك مرؤوسيهم حيث نجد المدير أو الموظف العمومي يتعامل مع وظيفته كما لو أنه يدير شأنًا خاصًا، ونلاحظ في بعض الحالات وجود من يرفض، بل يناوئ أي قرارات عليًا باستبعاده من وظيفته أو نقله إلى وظيفة أخرى.
وفي ظِلِ ضعف الرقابة والمحاسبة والمُساءلة نجد بعضهم لا يتورع عن استخدام كل ما هو تحت تصـرفه من ممتلكات ومتعلقات الوظيفة التي يشغلها - مثل الآليات والمركبات وأجهزة الحاسوب والاتصالات حتى الأدوات والأثاث المكتبي وكل ما بعهدته من أموال وتجهيزات مخصصة لإدارة وتنفيذ مهام وأنشطة الوظيفة - واستغلالها في تحقيق مصالحه الخاصة على المستوى الشخصـي والأسري وما إلى ذلك.
من المفاهيم المهمة التي يرسخها النموذج الڤِيبري أن البيروقراطية هي عملية «إدارة الموظفين»، ومن ذلك برز الاهتمام بفحص كفاءة النموذج، وقدرته على استيعاب خصائص الإدارة، وكذا فاعلية الجهاز الإداري للدولة عند تبني الإصلاح البيروقراطي. لعل ذلك يفسـر انتشار المفهوم في إطار علم الإدارة أكثر منه في علم السياسية.
ولا شك في أن الأجهزة الإدارية "البيروقراطية" في البلدان العربية والنامية بصفة عامة قد تعمل في ظروف تتسم بالشح في الموارد المالية والبشـرية، وليس ذلك بسبب انخفاض الميزانيات أو أجور القطاع العام فحسب، ولكن في بعض الحالات بسبب الضعف الشديد في القوة العاملة الماهرة وانخفاض الدخل في المجتمع اللذين قلصا من قدرة هذه الأجهزة وفاعليتها[39].
مما سبق يمكن القول: إن معرفة تأثير البِنية البشـرية في مسار الإصلاح البيروقراطي الحكومي في الحالة اليمنية، يتطلب التحقق من التزام الجهاز البيروقراطي بمعايير النموذج الڤِيبري في استقطاب واختيار، ومن ثم تعيين وترقية القوى البشـرية العاملة لشغل الوظائف العامة، أهم هذه المعايير: معيار التأهيل والتخصص (أ)، ومعيار الكفاءة والجدارة (ب).
وصف "ڤِيبر" البيروقراطية الصينية في عهده بأنها غير متخصصة، وعزى ذلك إلى أنها لم تهتم بالمؤهلات العلمية والفنية التي تلزم وظائف محددة، فضلًا عن أنها لم تعد التدريب ضروري لشغل الوظيفة؛ إذ كان كل ما يلزم لقبول المرشح هو حصوله على قدر من المعرفة الكلاسيكية والقيم الأخلاقية فحسب، ما أعاق نمو البيروقراطية وجعلها تعجز عن الإدارة الروتينية [40]، ومن ثم فإن البيروقراطية الڤِيبرية تشترط حصول المتقدم لشغل وظيفة حكومية علـى مؤهل علمي متخصص [41]، ويختلف مستوى المؤهل ونوعية التخصص وفقًا لمستوى الوظيفة المراد شغلها ونوعية المهام والأنشطة التي تؤديها هذه الوظيفة.
يعد توافر المؤهل العلمي المتخصص شـرطًا أساسيًا لاختيار الموظف الحكومي، يؤكد النموذج البيروقراطي الڤِيبري على أن الاختيار من حيث المبدأ يجب أن يتسم بالموضوعية والحياد؛ إذ لا يكون اختيار الموظف لأنه قريب أو صديق أو زبون أو عميل لمن اختاره، وإنما على أساس مواصفات عامة يخضع لها جميع المرشحين دون تمييز إلا بموجب أهليتهم المتحققة علنًا، بناء على مباراة وألقاب [42]، حيث يخضع المتقدمون لاختبار أو مسابقة عامة تحدد كفاءتهم وجدارتهم بالوظيفة ويتعين عليهم اجتيازها بنجاح [43]، وبالطريقة ذاتها يجرى العمل بمعيار الكفاءة والجدارة عند ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى.
في الحالة اليمنية نجد أن نظم اختيار وتعيين موظفي الدولة في ظِلِ النظام الشمولي الذي جمع بين الحكم القبلي والعائلي والفردي، واعتمد على الفساد عنصـرًا أساسيًا في ضمان استمرار ولاء المواطنين له، يخضع كما هو الحال في النظم المشابهة في الدول العربية إلى معايير القرابة والانتماء القبلي والسياسي المشار إليها دون الاعتماد على معايير الكفاءة الاستحقاق.
وفضلًا عن ذلك فقد أدت جملة من العوامل الداخلية والخارجية إلى اختلال معايير اختيار موظفي الجهاز الإداري لدولة الوحدة والحيلولة دون الالتزام بالمعايير البيروقراطية المشار إليها في استقطاب واختيار وتعيين القيادات الإدارية ومرؤوسيهم من الموظفين العموميين، وفقًا للمواصفات الكمية والنوعية للبُنية البشـرية التي تتلاءم مع المهام والأنشطة الموكلة للجهاز البيروقراطي للدولة الوليدة، ولعل أبرز تلك العوامل يتمثل في: الفائض العددي الكبير في العنصـر البشـري الذي خلفه دمج الجهازين البيروقراطيين في الشطرين السابقين [44] لاسيما الفائض الذي خلفه الجهاز البيروقراطي لما كان يسمى دولة «الجنوب» التي شهدت طفرة في التوظيف في ظِلِ نظام اشتراكي جعل ما يقارب نصف سكنها موظفين عموميين [45]؛ لذلك نلاحظ أنه عندما سعت الحكومة لإجراء إصلاحات باتجاه تقليص حجم البِنية البشـرية، فقد كان أغلب الموظفين المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية، الأمر الذي أظهر هؤلاء كضحية، لاسيما أن الإصلاحات في هذا الإطار لم تثمر عن جهود حقيقية في الحد من انتهاكات النظام البيروقراطي.
يضاف إلى ذلك ما نتج عن سياسة المحاصصة السياسية في التوظيف - بحسب ما أشرنا إليه سابقًا - التي عمدت الأحزاب الحاكمة إلى إتِباعها منذ بداية المرحلة الانتقالية للوحدة واستمرت في مراحل لاحقة مختلفة.
وفضلًا عما ذكر فقد نتج عن حروب الخليج "الأولى، والثانية"، عودة نحو مليون مغترب يمني معظمهم ممن كانوا في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق [46]، وقد اضطرت الدولة لاستيعاب مئات الآلاف منهم في الوظائف الحكومية، بعد أن شكلوا عبءً كبيرًا على الاقتصاد الوطني الذي كان يعتمد أساسا على تحويلاتهم المالية قبل عودتهم.
لقد حالت إشكالية تضخم البِنية البشـرية [47] في الجهاز البيروقراطي، التي أنتجتها عوامل الموروث الإداري، فضلا عن التوظيف السياسي ومظاهر الفساد في التوظيف، وغير ذلك من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، حالت جميعها دون قيام هذا الجهاز بدوره التنمية وحولته إلى مجرد مؤسسة ضمان اجتماعي، كما حالت دون اتباع الأساليب العلمية الحديثة في استقطاب واختيار وتعيين القوى البشـرية والقيادات الإدارية المؤهلة والمتخصِصة للنهوض بالمهام والوظائف التنموية المطلوبة من الأجهزة العمومية، وقد ترتب عن هذه الإشكالية ترهل أجهزة ومؤسسات الدولة أصابت أداء أجهزة الدولة، وأعاقت إلى حد كبير مسار الإصلاح والبناء البيروقراطي والمؤسسي فيها.
يقودنا البحث إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات الإصلاحية، على النحو التالي:
الاستنتاج: فرضت التعيينات المبالغ فيها في المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة -والتي تمت غالبا بفعل المحاصصات السياسية- حالة من التضخم في حجم هذه القيادات، أدت بدورها إلى تضخم الهيكل البيروقراطي العام للدولة، وزيادة عدد وحداته الإدارية عن الحاجة الفعلية. وكذلك على مستوى كل وحدة زادت معدلات الإدارات في المستويات العليا على نحو لا يتناسب مع معدل الإدارات في المستويات الوسطى والدنيا.
الإصلاح المقترح: تبني استراتيجية جادة لترشيق الهيكل البيروقراطي للدولة اليمنية ودمج وحداته ذات المهام والاختصاصات المتشابهة، في إطار استراتيجية وطنية كبرى للإصلاح الإداري الشامل.
الاستنتاج: أدى ضعف معيار "العقلنة" -سيادة القانون والنظم الحاكمة للعمل- إلى طغيان ما يعرف بـ "شخصنة" الإدارة في الجهاز البيروقراطي للدولة اليمنية، ومن ثم تعامل القياديات الإدارية مع المناصب التي تشغلها والممتلكات العامة الواقعة تحت سلطتها كأملاك خاصه، وسيطرت الاجتهادات والمصالح الشخصية على القرارات الإدارية.
الإصلاح المقترح: اعتماد مدخل الإصلاح المؤسسي كأحد الركائز الأساسية للإصلاح الإداري الشامل مستقبلا، ونقصد هنا بالإصلاح المؤسسي؛ تفعيل القواعد والنظم والمعايير المؤسسية في أجهزة الدولة وضمان تحييد الاجتهادات والأهواء والمصالح الشخصية للرؤساء والمرؤوسين في أجهزة الدولة عن إدارة هذه الأجهزة وتسيير شؤونها.
الاستنتاج: من حيث الكم، اتسمت البنية البشرية للجهاز البيروقراطي اليمني، بالتضخم العددي، كنتيجة طبيعية للتضخم الحاصل في البنية الهيكلية -المشار إليه سابقا- إلى جانب أسباب أخرى أبرزها (اختلال معايير التعيين في الوظائف العامة). أما من حيث الكيف، فإن الكادر البشري يعاني الكثير من الاحتلالات في مستوى التأهيل والتدريب وتنمية القدرات، وهو ما انعكس سلبا على كفاءته ومستوى فاعلية أداءه.
الإصلاح المقترح: إعادة هيكلة القوى العاملة في الدولة بالتوازي مع تنفيذ المقترح السابق الخاص بترشيق الهيكل العام للدولة ودمج وحداته الإدارية، وفي ظل استراتيجية شاملة تضمن إيجاد البدائل اللازمة لإعادة تأهيل واستيعاب القوى الفائضة، وعلى رأس هذه البدائل تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.